كثراً ما يتسأل المرء عن سبب الحروب والقلاقل والإضطرابات والإنقلابات في معظم البلدان الإسلامية خلال الأربعة عشرة قرناً الماضية، فمن حروب الردة إلى حروب الفتوحات إلى جور الولاة وتصفية الكثير منهم، إلى وقوع المسلمين تحت الإستعمار الأوروبي، ثم حرب التحرير، وأخيرا سلسلة من الإنقلابات تُوجت بثورات عارمة، وصاحب كل ذلك خسائر بشرية هائلة ودمار كبير في الممتلكات، عمل على تخلف الدول الإسلامية عن ركب الحضارة لعقود، إن لم تكن لقرون طويلة. موقع (Wars in the World) يورد 218 مجموعة مسلحة غير شرعية في الشرق الأوسط فقط وأكثر من 335 مجموعة في أفريقيا, وأسيا معظمها في الدول الإسلامية، وبذلك تعتبر الدول الإسلامية هي البؤر الساخنة على وجه البسيطة.
تلازم الحروب بدار الإسلام يؤكد أن المشكلة جذرية في بنية الدولة الإسلامية أكثر من أن تكون بسبب التغييرات الدولية أو الإقليمية، وأن منهج بناء الدولة في الدول التي جعلت الإسلام مرجعاً وحيداً لها لم يرقي بعد إلى صيغة توافقية واضحة يتفق عليها الحاكم والمحكوم، بالمقابل يرفض قطاع من المسلمين تبني مفاهيم الحداثة التى وصل إليها العقل الغربي وتبنتها شعوبهم ليكون الفيصل والركيزة في بناء الدولة الحديثة. فركائز الدولة الثلاث: الشعب والأرض ونظام الحكم، لا يوجد هناك إختلاف على العنصرين الأولين في معظم الثقافات، ولكن هناك خلط كبير وضبابية عند المسلمين في العنصر الثالث وهو نظام الحكم، والمفاهيم القرآنية بالخصوص؛ مثل مبداء الشورى جُلها عام حمال أوجه يحتمل أكثير من تفسير.
يقول أندرسون: أن الدولة مشروع متخيل؛ أي أن الشعب يتفق على نمط معين من الحكم، والقوانين المنظمة له، وبذلك فإن المواطن في الدول الغربية على بينة من قوانين نظام الحكم في بلده بالتفصيل الممل، ويدعن لذلك النظام عن رضا، بل يدافع عنه كجزء من المواطنة الفعالة، وتعمل النخبة ومؤسسات الدولة على سد الفراغ التشريعي الذي قد ينتج بين الحاكم والمحكوم.
في الدول الإسلامية لا يوجد إتفاق على نظام حكم معين، وكثيرا ما يقوم الخليفة أو الأمير أو الوالي أو الرئيس أو الملك بفرض نظام يراه الأفضل. من الناحية الدينية لم يتحدث القرآن عن الحكم، وتحدث كثيراً عن القضاء والعدل، وحتى الكلمات الواردة في الحكم تعني القضاء، بدليل أن المسلمين إحتاروا ماذا يسمون من جاء بعد النبي (أبوبكر الصديق) ليحافظ على إستمرار الدعوة إلى الإسلام فسموه خليفة رسول الله، بل أن القرآن الذي عرض مسائل كثيرة ثانوية بدقة عالية مثل رواية قصص الأنبياء، تجاهل مسالة الولاية الكبرى وشروطها ومن يتولاها وحق الرعية على الحاكم. عندما أخفق أصحاب المذاهب على الإتفاق على النصوص القاطعة حول نظرية الحكم في الإسلام جنحوا إلى التأويل وتفسير السنة، مما أدى بهم إلى صناعة أمراء وخلفاء ورؤساء وملوك وسلاطين. وبذلك فإننا إذا نزعنا القشور الخارجية للصراع بين المجموعات المتقاتلة مثل الجهوية والقبلية والطائفية والأنانية الحزبية (وهو موجود في معظم ثقافات الشعوب) فإننا نجد صراعاً أيديولوجيا صادماً بين المجموعات المتناحرة عن شكل الدولة.
قد يكون من الأجدر أن نتوقف عند محطات محورية شكلت منعرجا خطيرا في تاريخ المسلمين، أول هذه المحطات حروب الردة، التي يتفق الكثير من المؤرخين أنها كارثة إنسانية حدثت بسبب غياب مفهوم الدولة، وأن رفض إيتاء الزكاة لا يستوجب تلك الحروب التي قتل فيها مئات المسلمين. المحطة الثانية هي الفتنة الكبرى التي إنتهت بقتل سيدنا علي بن أبي طالب على يد صحابي جليل من حفظة القرآن ومقرئه عبد الرحمن إبن ملجم، وتحول الدولة الإسلامية من حكم الخلافة (بالكفاءة وإنتخاب أهل الحل والعقد) إلى ملك عضوض عند بني أمية يرثون الأرض ومن عليها جيلاً بعد جيل، وسبب ذلك بالتأكيد غياب مفهوم الدولة ونظام الحكم الإسلامي الرشيد على وجه الخصوص.
المحطة الثالثة في العصر الحديث هي سقوط الخلافة العثمانية في سنة 1924م، والتي كان لها صدى كبير وردود أفعال كثيرة في الدول التي لا تخضع للسلطة العثمانية كمصر والهند، ففي مصر كتب الشيخ على عبدالرازق كتابه المثير للجدل “الإسلام وأصول الحكم”، والذي يؤكد فيه أن لا علاقة للدين بالخلافة والحكم، مما جعل الأزهر يمنع تداول الكتاب وقام بمحاكمة الشيخ الجليل. بالمقابل حاول الشيخ محمد عبدة والشيخ حسن البناء التوفيق بين الدولة المدنية الحديثة والشريعة الإسلامية، وأخيراً وصل أبوالأعلى المودودي إلى أن الدولة الإسلامية مزيج من العنصر الديني والعنصر الدنيوي، وبذلك فإن فكر الإخوان المسلمون كان متقدماً على غيرهم من حيت تبني مفاهيم الحداثة، فمثلا يقول حسن البناء (الحكومة في الإسلام تقوم على دعائم ثلاث: مسؤلية الحاكم، وحدة الأمة وإحترام إرادتها. أي أن الحاكم مسئول بين يدي الله وبين الناس، وهو أجير لهم وعامل لديهم) وهذا القول يمثل العقد الإجتماعي في الإسلام الوسطي: أي إذا أصاب الحاكم في مهامه له أجره، وإذا أساء فعليه عقابه وإقصاءه.
هذا العطاء الفكري الضخم في الثلاثينات والأربعينات، على معظم ربوع الدول الإسلامية رغم أن معظم ديار المسلمين كانت واقعة تحت الإستعمار الأوروبي إنطفأت جذوته وأعقبها حكومات الجنرالات، وتوالت معها الإنقلابات دامت لأكثر من نصف قرن، بدأت بمصر في 23 يوليو 1951 م وإنتهت بمريتانيا في بداية الألفية الثالثة. في هذه الفترة توقف التفكير في نظرية الحكم، وأصبح شموليا دكتاتوريا للأنظمة الجمهورية، وعائليا متسلطاً للأنظمة الملكية، وهكذا ثم إستبدال المستعمر الغربي بالمستعمر الداخلي من طينة أهل البلد.
المحطة ما قبل الأخيرة المهمة في تاريخ العرب والمسلمين هي هزيمة 5 يونيو 1967 م، تلك الهزيمة التي إجتاحت فيها إسرائيل أربعة دول عربية في ستة أيام، وأزالت المشروعية عن أنظمة الحكم الشمولي، وكشفت اللثام عن ضعفها وسؤ إدارتها وتأخر أدواتها، حتى أعتبر بعض المؤرخين أن هزيمة 67 هي قاع القاع لإنحطاط الدول العربية والإسلامية، وكان ردة الفعل الكبرى لهذه الهزيمة ظهور ما يسمى بالصحوة الإسلامية. بدأت الصحوة الإسلامية في منتصف السبعينات وإنظم إليها ألآف الشباب رافضين الوضع القائم، ونظر لها الكثير من المفكرين والشيوخ جلهم من الإخوان المسلمين.
هذه الصحوة كان يمكن لها أن تكون تكملة لما بذل في الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي لتخرج بنظرية أو نمط حضاري محدد للحكم متوافقا مع تعاليم الإسلام ومتتطلبات الحداثة، وكان هناك العديد من المحاولات الخجولة لتعاطي نظرية الحكم في الإسلام، منها ما صرح به مفتي الجمهورية المصرية الدكتور علي جمعة حيث يقول: أن الدين هو السقف الذي يقف عنده الجميع وينبغي أن يتدخل الدين بشكل أساسي في التشريع ويظل بعيداً عن السياسة التي قوامها البرامج التنافسية والخلافات لكل الأطراف.
لم يتطور الفكر السياسي الإسلامي في هذه الحقبة وتفرقت النخبة الى العديد من الملل والنحل المتباينة فكرياً مثل السلفية، والسلفية الجهادية، والتكفير والهجرة، والمذاهب الشيعية، والإخوان، والتحرير الإسلامي، بالإضافة إلى المذاهب العلمانية، وأصبحت الفرق متناحرة فيما بينها، بل هناك من يدعي أنه ينتمي إلى الفرقة الناجية، وساعد على الإنقسام تدخل الحكومات بأموال النفط لفرض عقائدها (وإن كانت متخلفة) على شعوب كثيرة في العالم الإسلامي، بل أن الصحوة أصبحت الآن في طي النسيان بعد أن قضى عليها التيار السلفي الذي لا يؤمن بالقيم الحضارية مثل الديموقراطية والإنتخابات والتداول السلمي للسلطة، ومبداء تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة، وهو منبهر بالغرب وتقدمة وحضارته، رافضاً لقيمه الإنسانية وللألياته ووسائلة، قابعا في الزمن الماضي لا يتقدم عنه قيد أنملة. فمثلا طاعة ولي الأمر واجبة وإن جلد ظهرك والخروج عنه بدعة، والإمامة لا يستحقها إلا من كان قريشيا، ومجالس الشورى لا قيمة لها أمام سلطان الحاشية، أما مجارات الحكام والسلاطين الظلمة والعيش في كنفهم وتسويق شعاراتهم لا ضير فيه، وهناك العشرات من المواضيع التى تم شرعنتها من رجال الدين لتبرير مواقف السلاطين قديما وحديثا.
خلال الثلاث عقود الماضية أخفقت المجموعات والحكومات التي رفعت شعار الإسلام التقليدي السلفي في الوصول إلى صيغة مرضية للحكم، ففي السعودية لازالت دولة ملكية لا علاقة لها بالدولة المدنية وتستفرد عائلة بإسم الدولة، أما في إيران، فإن ولاية الفقية يجعل من الفقيه أعلى سلطة من الدستور، وبالمثل تراجع السودان عن النهج الإسلامي، ولا ننسى صيغة الإسلام المتخلف عند طالبان أو الشباب الإسلامي بالصومال، أو داعش.
أخيراً جاءت الإنتفاضات والثورات الشعبية لرفض الواقع المر المتمثل في الحكم الشمولي وعجزه عن تلبية متطلبات المجتمع المادية والمعنوية، ومع هذه الثورات عاد الحديث عن نظام الحكم في الدول الإسلامية، بل أصبح الشغل الشاغل لقطاعات كبيرة من المجتمع. ورغم أن الإسلام السياسي قد شارك بقوة في إنجاح هذه الإنتفاضات الجماهيرية إلا أنه عجز عن إيجاد البديل للحكم الشمولي، وعجز عن إيجاد صيغة توافقية بديلة للحكم، مما أدي إلى ظهور فرق وزعامات كثيرة تعتنق مذاهب وأيديولجيات متباينة تحارب بالسلاح من أجل إظهار معتقداتها، فالإنفصاليون يرون أن الحل يكمن في تطبيق الفيدرالية، والسلفيون يرون الحل في قيام خلافة أو إمارة إسلامية، والقوميون يرون أن ألأمن والامان في النظام الشمولي، وآخرون يقدسون النظام القبلي والإذعان إلى العرف الإجتماعي القديم. ورغم أن جميع المؤشرات الدولية للتنمية وحقوق الإنسان كانت سيئة لسنوات طويلة عند النظم الشمولية، إلا أنه هناك من يتحسر على سقوطها وزوالها، وذهاب رموزها.
وعلى الرغم من التشتت الكبير في القوى الفاعلة وإنتكاسة الإنتفاضات في كل من مصر واليمن وليبيا وسوريا والعراق، إلا أن مسار التغيير لن يتوقف، وهذا التغيير العميق والبطئ في بنية وثقافة شعوب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينبئ بالاعودة إلى الحكم الشمولي، وإن نجح (مؤقتا) في مصر، فبالأمس نحن على أبواب نقل السلطة من الأباء إلى الأبناء في العديد من الدول العربية منها ليبيا ومصر واليمن وسوريا، واليوم لم تعد تُفكر الحكومات في ذلك وتنتظر سقوطها في أي لحظة.
كما أن إنتكاسة مشروع الصحوة وخضوعها تحت التيارات السلفية الجهادية المتطرفة أوجد إسلاماً غريبا يقول عنه سايمون هيتنكتون في كتابه صراع الحضارات “أن كل المسلمين إرهابيون”، وبذلك يجب نقل الصراع إلى داخل الحواضر الإسلامية، وتجنيب الغرب ويلاته، وهو ما نراه اليوم في دول الشام ومصر وشمال أفريقيا.
رغم ذلك فإن تبلور الفكر السياسي عند المسلمين في قالب متحضر آت لا محالة، وعندها يسود تياراً وسطياً جديداً تتوافق عليه النخب المثقفة، وسيحمل على عاتقه مهمة تحديث الخطاب الإسلامي بناء على تحديث آليات الحكم. ومن الأمثلة الناجحة لأنظمة الحكم المنتمية للإسلام ما نراه في كل من ماليزيا وتركيا اللتان تزخران بتنوع عرقي وثقافي وديني كبير، وهما من الدول الإسلامية الأكثر نمواً وإزدهاراً، وهما متوافقتان مع قيم الحداثة والقيم الإنسانية الخالدة.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.





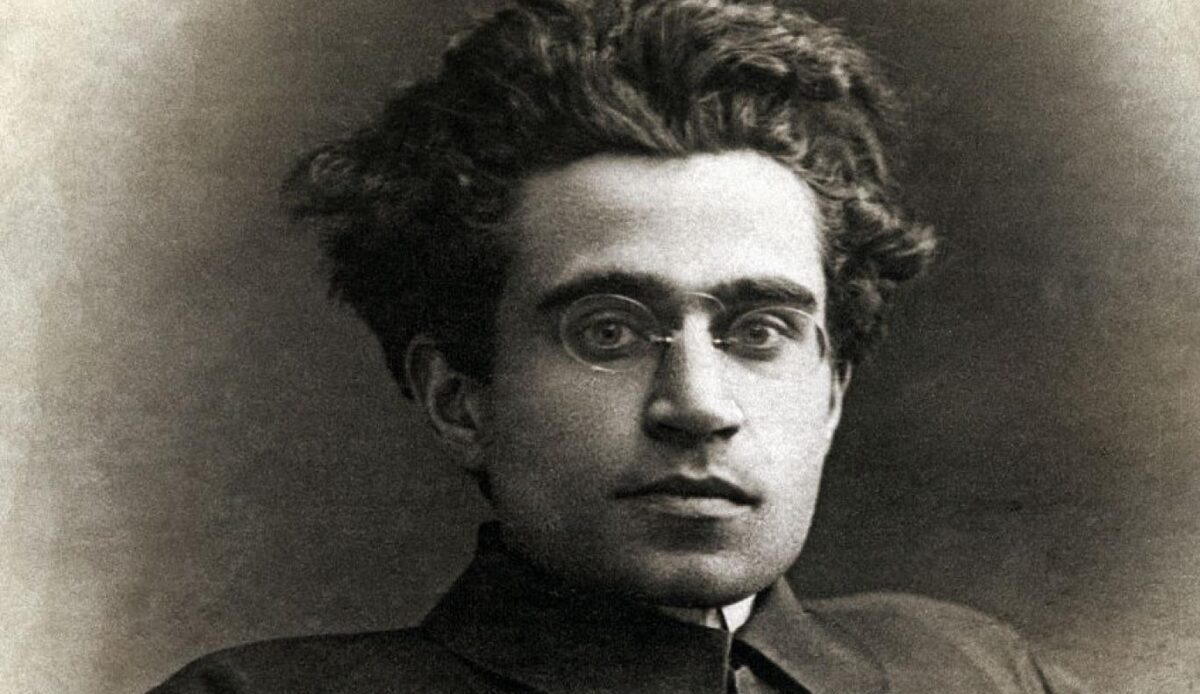


من علامات الساعة نطق الرويبضة . . فالرسول صلى االله عليه وسلم بلغ الرسالة و أدى الأمانة وأسباب الصراع البعد عن الدين وهذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم ستتفرق امتي على 73 فرقة .. الحديث