لقد أعلى الله من قيمة الإحسان إلي الوالدين، وجعلها الرابطة الأولي بعد رابطة العقيدة، فقرن شكره بشكرهما، والإحسان إليهما بعبادته وتوحيده، فقال – سبحانه وتعالى:
{وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ} (لقمان:14)
“وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا} (الإسراء:23)
“.. بهذه العبارات النديّة، والصور الموحية -كما جاء عن صاحب الظلال، رحمه الله- يستجيش القرآن الكريم وجدان البر والرحمة في قلوب الأبناء. ذلك أن الحياة وهي مندفعة في طريقها بالأحياء، توجه اهتمامهم القوي إلى الأمام، إلى الذرية، إلى الناشئة الجديدة، إلى الجيل المقبل. وقلّما توجه اهتمامهم إلى الوراء، إلى الأبوة، إلى الحياة المولّية، إلى الجيل الذاهب! ومن ثم تحتاج البنوة إلى استجاشة وجدانها بقوة لتنعطف إلى الخلف، وتتلفت إلى الآباء والأمهات.
إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد، إلى التضحية بكل شيء حتى بالذات. وكما تمتص النابتة الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي فتات، ويمتص الفرخ كل غذاء في البيضة فإذا هي قشر، كذلك يمتص الأولاد كل رحيق وكل عافية وكل جهد وكل اهتمام من الوالدين فإذا هما شيخوخة فانية – إن أمهلهما الأجل – وهما مع ذلك سعيدان!
فأما الأولاد فسرعان ما ينسون هذا كله، ويندفعون بدورهم إلى الأمام. إلى الزوجات والذرية.. وهكذا تندفع الحياة.
ومن ثم لا يحتاج الآباء إلى توصية بالأبناء. إنما يحتاج هؤلاء إلى استجاشة وجدانهم بقوة ليذكروا واجب الجيل الذي أنفق رحيقه كله حتى أدركه الجفاف”.
والملاحظ في جميع الآيات التي جاء فيها الأمر بالإحسان إلى الوالدين، عُدّي الإحسان في الوصية بالوالدين بـ (الباء) التي تدل علي إلصاق الإحسان بالوالدين دون واسطة ولا فصل، وجعل الأمر به بالنسبة لهما تاليا في الذكر للأمر بعبادة الله وحده، أو النهي عن الإشراك به، وفي هذا رفع لمقام الأبوة والأمومة أيما رفع! [محمود شلتوت: تفسير القرآن الكريم ص 316، دار الشروق]
هذه الرفعة لمقام الوالدين، جعلت البرّ بهما، والإحسان إليهما، أفضل منزلة من الجهاد – ذروة سنام الإسلام -، إلا في حالات خاصة ذكرها أهل العلم عند قضية تعيّن الجهاد..
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: “جاء رجل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحيٌّ والداك، قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد “[صحيح البخاري، رقم 2842].
وفي رواية: “أتي رجل فقال: يا رسول الله: إني جئت أريد الجهاد معك، ولقد أتيت وإنّ والدايّ يبكيان، قال: فارجع إليهما، فأضحكهما كما أبكيتهما ” [رواه أبو داود، وصححه الألباني برقم 2205، ورواه ابن ماجه وصححه الألباني برقم 2242].
ولا غرو أن جعل الله – عز وجل – رضاه من رضا الوالدين، وسخطه من سخط الوالدين..
جاء في الحديث “رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين” [رواه الترمذي موقوفا ومرفوعا، والحاكم وقال: علي شرط مسلم، والبخاري في الأدب المفرد].
وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد ” [صحيح ابن حبان].
وإذا كان الإحسان للوالدين بهذه المنزلة الكبيرة، والدرجة الرفيعة، فإن الإحسان للأمّ منزلته أعظم، ودرجته أرفع..
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمّك. قال ثم من؟ قال: ثم أمّك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمّك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك ” [صحيح البخاري، رقم 5626].
وما نالت الأمّ هذه المنزلة من البر والإحسان إلا لقلبها، الذي لو كان ما فيه من حنانٍ ماءً وفاض على الدنيا -على حد تعبير الدكتور “عبد الرحمن رأفت الباشا”- لملأ البحار والأنهار.. ولو أن ما فيه من رأفةٍ ضياءً وأشرق على الكون لأخمل الأفلاك، وكسف الشمس والقمر..
قيل – في قصة رمزية – أن غلاما يافعا، أغراه أحد الأشرار بالجواهر والدّرر، في مقابل أن يأتيه بقلب أمّه.. وسقط الغلام ضحية الإغراق، فذهب وأغمد خنجره في صدر أمّه، وأخرج قلبها، وهرع يجري لكنه من فرط سرعته هوي إلى الأرض..
وهنا ناداه قلب أمّه صائحا: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟!
وهنا شعر الغلام أن صوت أمّه الحنون عليه، هو غضب من السماء، فأدرك خطأه وأمسك خنجره، ليطعن به نفسه، وعندئذ ناداه قلب الأمّ: ” ولدي، كُفّ يدك ولا تطعن فؤادي مرتين”.
ولله درّ الشاعر الذي صوّر لنا تلك الأسطورة التي أغري فيها إبليس فتي طائشاً، فقال:
أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا … بنقوده كي ما ينال به الوطر
قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى … ولك الجواهر والدراهم والدرر
فمضى وأغمد خنجرا في صدرها … والقلب أخرجه وعاد على الأثر
لكنه من فرط سرعته هوى … فتدحرج القلب المضرج إذ عثر
ناده قلب الأم وهو معفّـر … ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟!
واستل خنجره ليطعن نفسه … طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر
ناداه قلب الأم كف يدا ولا … تطعن فؤادي مرتين على الأثر!
ولا تعجب من تلك المنزلة العظيمة (منزلة الإحسان بالوالدين)، حيث كانا السبب في وجودك، والأصل في تربيتك وتعليمك، وفيهما من صفات الربّ الرحيم الودود الغفور الكثير، حيث الرعاية الخالصة، والحب المجرد، والعطاء بلا حدود وبلا مقابل، وقبولك علي عيبك، فإن شردت عنهما وابتعدت، وجدتهما – علي شوق – في انتظارك!
فلا جرم إذا تضاعف حقهما، وعظم شكرهما..
قال صلي الله عليه وسلم “لن يجزي ولد عن والده حتى يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه” [صحيح مسلم، رقم 1510].
وجاء رجل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن لي أمّا بها من الكِبر والعجز ما جعلني أحملها على ظهري كلما أرادت قضاء الحاجة.. فهل أديت حقها يا أمير المؤمنين؟! فقال عمر: لا.. إنك لم توفها حقها؛ لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمني بقاءك.. وأنت تصنعه بها وأنت تتمني فراقها!
ولذا نلحظ الوصية للوالدين في القرآن الكريم بالإحسان إليهما، دون النهي عن الإساءة إليهما، كما جاءت في تفسير قوله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا..} (الأنعام:151)
“ولقد جاءت الوصية الثانية: “وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا” في قوله تعالى: “قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.. ” (الأنعام: 151) بأسلوب الأمر بالواجب المطلوب، وهو الإحسان: ولم تذكر بأسلوب النهي عن المحرّم وهو الإساءة كما جاءت الوصية الأولي {أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا} سموا بالإنسان عن أن تظن به الإساءة إلي الوالدين، وكأن الإساءة إليهما، ليس من شأنها، أو ليس من شأنه أن تقع منه حتي يحتاج إلي النهي عنها؛ ولأن الخير المنتظر من هذه الوصية -وهو تربية الأبناء علي الاعتراف بالنعم وشكر المنعمين عليها- إنما يتحقق بفعل الواجب وهو الإحسان، لا بمجرد ترك المحرّم وهو الإساءة، لهذا وذاك قال الله تعالي فيها {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} ولم يقل “ولا تسيئوا إلي الوالدين”، فليس من المطلوب سلب ضرر وإيذاء، وإنما المطلوب إيجاد خير ونفع بهما ترتبط القلوب، وبهما تنمو الفضيلة، وعليهما تشيد الأسرة وتمتد غصونها” [محمود شلتوت: مصدر سابق ص 316].
ولما كان من البديهي – في منطق القرآن والفطرة – ضرورة الإحسان إلى الوالدين، جاءت الإساءة إليهما مغلّظة، بل، ومن أكبر الكبائر..
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، قال: كنا عند رسول الله صلي الله علي وسلم، فقال: ألا أنبّئكم بأكبر الكبائر ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور، وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكرّرها حتي قلنا ليته سكت” [صحيح مسلم، رقم 87].
وإذا كان عقوق الوالدين من أكبر الكبائر وجاء بعد الإشراك بالله – كما جاء في الحديث -، فإن الإحسان للوالدين من أوجب الواجبات، وأعظم القربات، ولذا جاء في معظم الآيات بعد الأمر بعبادة الله وتوحيده.
تأمّل ما تقدّم من منزلة الوالدين والإحسان إليّهما في الإسلام، وما فعلته الحضارة المادية بالوالدين وبتدمير الأسرة والعلاقات العائلية، وتقطيع ما أمر الله به أن يوصل. فالأبناء – في الحضارة المادية – يقبلون على ملذات الحياة وشهواتها، وينسون آباءهم وأمهاتهم، وقلما يلتقون بهم إلا في أعياد الميلاد، فإذا كبر السن بهؤلاء الآباء، لم يجدوا مأويً إلا في بيوت العجزة والمسنين!
أما الأبناء –في تربية الإسلام-، فهم الذين يتلمسون -في كل لحظة- رضا الله -عزّ وجلّ- برضا الوالدين والإحسان إليهما..
هذا، ويبقى المعدِن على أصالته، والإيمان علي حقيقته، والعبودية لله علي جوهرها، ما امّتثل الإنسان ووقف عند قول الله تعالي:
“وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} (الإسراء: 23،24)
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.



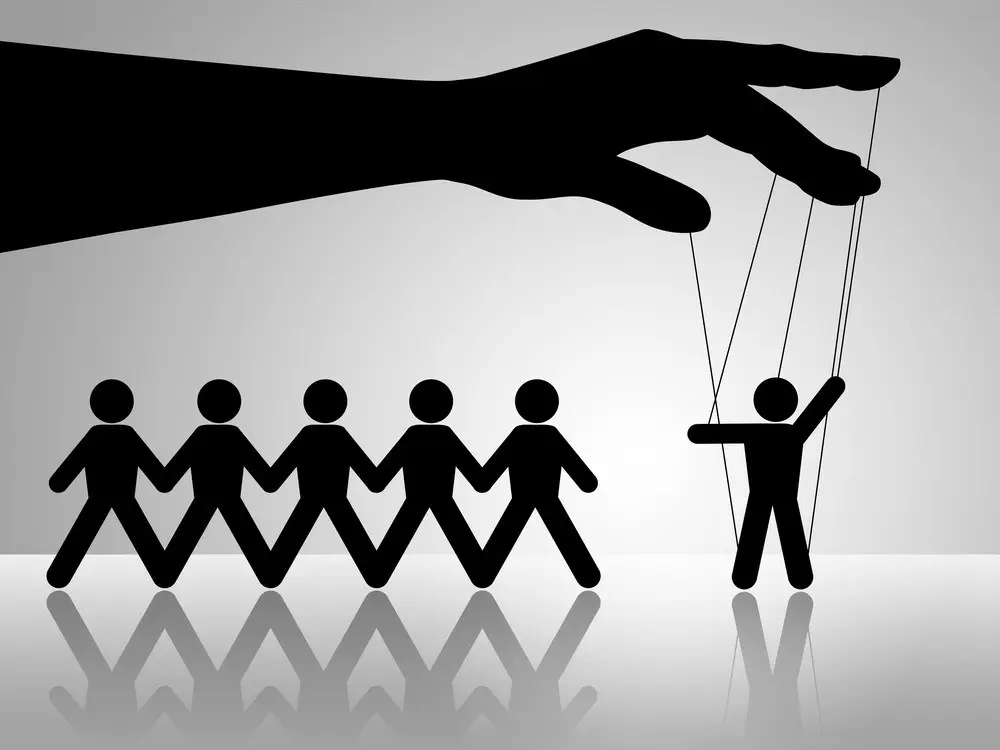




اترك تعليقاً