البيت الفلسطيني رمز انتماء، وهوية شعب، وفكرة راسخة في ذاكرة أجيال متعاقبة؛ عاشت على أرض فلسطين وخارجها، وظل البيت “الدار” مصدر فخر وتباهٍ واعتزاز، واِنساب هذا التفاخر والاعتزاز في القصص والروايات والأشعار، والأهازيج والمناسبات الشعبية، وكتابات المؤرخين والباحثين، وأعطى الروائي الفلسطيني نمر سرحان في موسوعته “الفلكور الفلسطيني” مكانة مرموقة للبيت، الذي تناقل الحنين له والاحتفاظ بذكرياته الفلسطينيون، جيلاً بعد جيل.
البيت الفلسطيني “الدار”.. حكاية ممتدة
مثَّل المشهد المعماري الفلسطيني، نتيجة تراكمية طويلة الأمد للحضارات والثقافات التي نشأت على أرض فلسطين، مشكلةً البيوت والحارات، والمعالم العمرانية الحضارية، ويحتوي بعضها على أكثر من عشرين طبقة حضارية، وفي مناطق القدس والضفة الغربية وغزة وحدها، هناك ما يزيد على 10,000 موقع ومعلم أثري تنتمي لحضارات عدة: كنعانية، ومصرية، وآشورية، وبابلية، وفينيقية، وفلسطينية، ويونانية، ورومانية، وبيزنطية، وعربية إسلامية، وتركية عثمانية… وغير ذلك.
الأمويون الذين حكموا فلسطين بين عامي 660 – 750م، كان لهم دور بارز في شكل عمارة المنازل، والمساجد والقصور، وأشهرها قبة الصخرة. كما ازدهرت العمارة السلجوقية والأيوبية والمملوكية والعثمانية، كالمدارس والخانقاه الصلاحية والأسواق والحمامات والطرقات.
وفي مدينة نابلس على سبيل المثال، أُحصي في نهاية الفترة العثمانية، ثلاثة وعشرون مبنى باعتبارها قصوراً، وهي من البيوت المستقلة التي بنتها العائلات الثرية من الأعيان والحكام الفلسطينيين، ومنها يعود للقرن 17م، كقصور آل طوقان وآل هاشم، وفي القرن 19م، كقصور آل النابلسي وآل عبد الهادي. ونبغ في أواخر العهد العثماني بعض المعماريين المحليين في فلسطين، ومنهم: مرقص نصار في بيت لحم.
عاش الفلسطينيون في بيوتهم وحواريهم حتى نهاية العهد العثماني (1918م)، وبدء مرحلة الانتداب الإنجليزي، ومن ثم حلول إسرائيل مكانه (1948م)، واعتمادها منهجية تهجير السكان الأصليين، واستلاب الدور والعمائر الفلسطينية في حيفا والرملة ويافا والناصرة وعكا وطبريا وسخنين وشفا عمرو وعرابة البطوف والقدس ومناطق أخرى، وظلت مفاتيح البيوت الفلسطينية التي احتفظ بها أهل فلسطين (المهجَّرين)، تغذّي الذاكرة الجماعية، إذ خرج الفلسطيني من منزله وبلده، حاملًا أوراقه الثبوتية، ومفتاح داره، على أمل العودة من جديد. وللمفتاح شكل مميز؛ فهو مفتاح معدني كبير، يعلقه معظم الفلسطينيين على جدران منازلهم، وتتوارث العائلات هذا المفتاح، وبعض العائلات تدفن المفتاح بجانب الدار، ليصبح مفتاح العودة رمزًا لهوية فلسطين، والوفاء لها والانتماء لأرضها.
الطراز العُمراني للبيت الفلسطيني “الدار”
في الماضي، كان البيت الفلسطيني، عبارة عن غرفة كبيرة له شبابيك مرتفعة، ومصطبة مرتفعة، وفي صدرها أجران (خوابي) لتخزين البقول والخروب والعسل والجميد والحبوب والبصل والجبن والسمن واللبن المجفف واللحم المقدد، والقطين (التين المجفف)، وإلى جانبها جرار الزيت الفخارية، وخلف هذه الأجران (الخوابي) منطقة تسمى “الراوية”، تجلس فيها النساء، ويَروين فيها الحكايات. وفي الطابق السفلي للمنزل (قاع البيت) كانت تجتمع الحيوانات والأغنام والطيور الداجنة، وتخزين العلف، وأدوات الحراثة والفلاحة. وقد كانت المنازل تضاء بقناديل الزيت أو السراج.
وكان من أنواع الدور “البيوت” في الريف والمدن في فلسطين: الخشة، والسقيفة، والبانكة “البايكة”، وبيوت العقد، وبيت الهيش (غزة) – الحوش. وبيوت المناطر في الكروم والبساتين. وهذه الأشكال رغم تطورها عبر الزمن إلى أنماط عمرانية أحدث، لكن الدور الفلسطينية التي تركها أهلها، منذ سبعين عاماً تقريباً، ظلت بأشكالها وطرازها، حاضرة في الذاكرة لا يمكن نسيانها.
البيت “الدار” في وجدان الشعب الفلسطيني
البيت “الدار” له مكانة عاطفية مرموقة في الذاكرة الشعبية الفلسطينية، إذ إن الفلاح الفلسطيني، وكذلك الفلسطيني المشرد؛ أعطيا أهمية عظيمة لوجود البيت، فهو رمز للحسن الإنساني الغريزي في الرغبة بأن يكون للإنسان وجود ثابت في بيت، وعلى أرض، ومع أسرة، هذا فضلاً عن تعبير حقيقي من جانب الإنسان الفلسطيني في الانتماء والولاء للأرض.
وقد كان يجوع الفلاح الفلسطيني، ليوفر ما يُعينه على إكمال بناء بيته، وكانت مساعدة الفلاح في بناء بيته، واجباً أدبياً على كل أهل قريته، وهم يقومون بما يسمى “عونة” عند العقد، كمان أن أكثر أمنيات اللاجئ الفلسطيني في الشتات أن يكون له بيت، ففي المخيمات، أعطت “وكالة غوث اللاجئين للفلسطيني خيمة صغيرة، أو ساعدته في بناء غرفة واحدة، غير أن هذا اللاجئ سرعان ما تخلص من الخيمة، وأضاف للغرفة غرفاً أخرى، أو بنى بيتاً كبيراً متعدد الطوابق. وتحولت تلك المخيمات بمرور الوقت لتجمعات سكانية، بل ومدن مستقلة مثل “الوحدات” في الأردن، و”اليرموك” في سورية، و”صبرا” في لبنان، وغير ذلك. ونظراً لتمسكهم بالأرض وخيراتها، زرعوا حول بيوت المخيمات والتجمعات المكتظة، أشجار العنب والزيتون والتفاح والليمون.
البيت الفلسطيني كأي بيت عربي، هو حالة استجابة للحاجات المرتبطة بالواقع المعيشي والظرف الاجتماعي، مع مراعاة القيم الأخلاقية والمجتمعية السائدة، وكان نظام التجاور بين بيوت الحمولة الواحدة، هو تطور عن تجاور خيام القبيلة، فبنى أفراد الحمولة الواحدة بيوتهم متجاورة رغبة في تجاور ذي القربى، وتعاضد وتكاتف أثناء الشدة، ونأخذ على هذه الظاهرة مثالين: قرية دير الغصون (طولكرم)، وفي هذه القرية حارة الخليلية (بمعنى الناس القادمين من الخليل). وفي القدس، سكن أتباع الديانة الواحدة أو العرق الواحد بشكل متجاور، وهناك على سبيل المثال: حارة المسيحية، وحارة المغاربة.
البيت الفلسطيني “الدار” في الأمثال الشعبية
شاعت أقوال فلسطينية مأثورة، ربطت وجود البيت مع اجتماعات الأهل والأصدقاء والأحباب “البيت رمز سعادة، ولقاء اجتماعي”، وفي المثل الشعبي الفلسطيني: (ريت هالبيت يظل مفتوح، والحبايب تيجى وتروح). وحين تغادر البنت بيت أهلها إلى عش الزوجية، لا تنسى البيت الذي رباها، فذلك البيت لا يتخلى عنها حتى وهي في بيت زوجها (بيت رباني ما راح وخلاني).
ربطت المرأة الفلسطينية “البيت” وقيمته بوجود الرجل فيه، وتداولت النساء في الأوساط الشعبية عبارات: فالرجل هو “شمعة البيت”، و”عمود البيت”، وتشهد بذلك أساليب الدعاء بالخير، والتي تصدر من امرأة لأخرى، مثل: “الله يخلي لك عمود بيتك”.
يوم الأرض الخالد، ومفاتيح العودة، وذكريات الوطن المسلوب، وقصص البيوت “الدّور”، والمجابهة الحقوقية والإنسانية على جميع المستويات، عكست قضية شعب له حق في أرضه، ومقدساته، وبيوته “دوره”، وأراضيه، ومن بَقوا صامدين رغم الإغراءات التي لا توصف، إذ عُرض على أهالي حي سلوان في القدس مبالغ خيالية مقابل ترك بيوتهم في المدينة القديمة، ولكنهم ثابتون فيها، كشجر الزيتون والليمون. فالبيت الفلسطيني الرمزية الوطنية، والقيمة الأسمى بتجلياته التاريخية، وهو المنهل الأهم، والبئر الذي لا ينضب، لمختلف القيم الدينية والعادات والثقافة الاجتماعية الفلسطينية، لدرجة أنه أصبح الانتماء لهذا التراث رسالة ثقافية، متجاوزةً حدوده المكانية إلى فضاءات عالمية، وانتشرت البيوت الفلسطينية في جميع الحواضر العالمية من مخيمات الجوار الفلسطيني إلى أصقاع الأرض قاطبة.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.



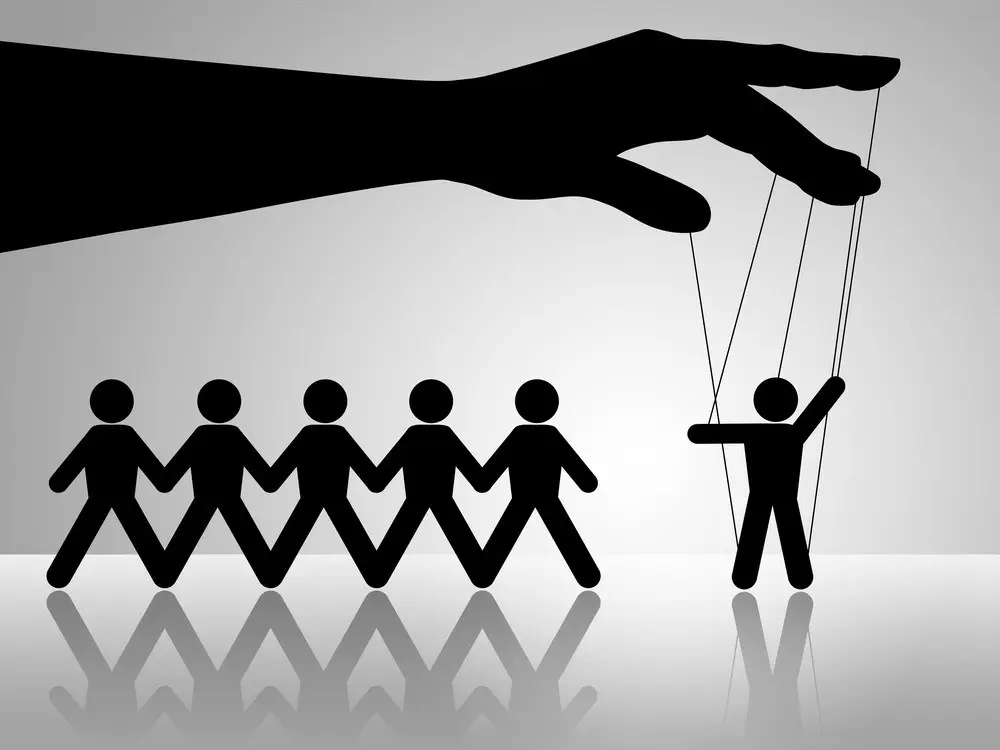




اترك تعليقاً